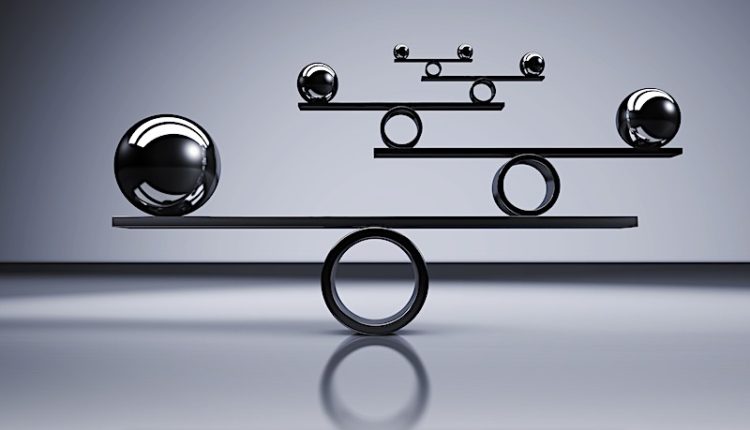
يقظة الصحابة ووقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الفتن
بقلم: يوجَل مان
يقع على عواتق المؤمنين عدَّة وظائف من شأنها ضمان العيش في جو مفعم بالحق والحقوق والأمن والأمان. إذ يجب عليهم بداية أن يوطدوا دعائم الأخوة التي تضمن الوحدة والاتحاد فيما بينهم؛ فيشيعون في معاملاتهم وعلاقاتهم الحب والاحترام والسلام والتعاون والتكافل، وينشِئون الأفراد والبلاد التي يشعر الجميع نحوها بالثقة والأمان؛ فلا يعتدي أو يتجاوز أحدهم على حق وحقوق أخيه فيها، ثم يعيشون بعد ذلك في يقظة وحذر وحساسية دائمة حفاظًا على هذا المناخ الآمن الذي أنشؤوه، وضمانًا لاستمراريته.
ولقد كان لدى الصحابة رضوان الله عليهم حساسية كبيرة تجاه الحوادث السلبية التي يسمعون بها ويرونها ويشعرون بها، على اعتبار أن هذه الحوادث ترمي إلى إحداث الفتن والاضطرابات. فكانوا يتخذون على الفور موقفًا منها؛ بدافع الشجاعة التي اكتسبوها من إيمانهم، وشعور المسؤولية الذي ينبع ويتغذى من أخلاقهم العالية وصفاتهم الإنسانية، ووجدانهم الذي انجلى وصقل بالعلم والعرفان. فكانوا يسعون ويعملون على درء الفتنة، وسد الفجوة، وقطع الطريق أمام الفساد. وعلى الرغم من أنهم يتغاضون ويعفون ويتسامحون في المشكلات التي تنال شخصهم دون أن يصعدوا الأمور أو أن ينثروا بذور العداء؛ فإنهم كانوا يضعون نصب أعينهم المسائل التي تهم المجتمع، ويتحركون من فورهم إن كان هناك أي تهديد أو خطر.
فإن اليقظة والانتباه المبكر في مثل هذه الحالات يحمل أهمية كبيرة في حل المشكلة والتغلب عليها، ولذلك كانوا يقومون بإبلاغ المسؤولين أو الهيئات المختصة قبل أن يتفاقم الأمر. وإذا كانت المشكلة يمكن حلها بالتنبيه والنصيحة، فلا يتوانون ألبتة في استعمالِ قوةِ وسحرِ البيان في حلها. فإذا تعذر عليهم تحقيق أحد هذين الموقفين بسبب الظروف المحيطة بهم، فإنهم على الأقل يتخذون موقفًا قلبيًّا، ويتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء من أجل الإصلاح. ولا يقفون ألبتة بلا حراك دون اتخاذ موقف إزاء الفتنة والفساد والظلم. ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الأمثلة من عصر السعادة النبوي ومن حياة الصحابة الذين يمثلون القدوة لهذه الأمة.
كتاب سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه
ظل المشركون طوال تسع عشرة سنة منذ اليوم الأول للبعثة إلى يوم صلح الحديبية ينكرون الإسلام ويحاولون بكافة الطرق القضاء على المسلمين واستئصال شأفتهم. وهذا ما دفعهم إلى الخيانة ونقض الصلح، فأغاروا على قبيلة خزاعة ليلًا، وكانت قد دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا منهم ثلاثة وعشرين نفرًا أغلبهم من الأطفال والنساء. فكان هذا بمثابة رفض للشروط والبنود التي تضمن للعدالة أن تتخذ مجراها؛ وفي الوقت نفسه بمثابة إطلاق إشارات عودة للأيام الخوالي من الظلم والبغي. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للخروج ثأرًا لهذه الخيانة ولمن قُتل غدرًا من خزاعة؛ إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر الجنود بأية معلومة تخص إستراتيجية التحرك.
إلا أن سيدنا حاطب بن أبي بلتعة فطن إلى مقصد الغزوة، فأرسل كتابًا إلى أهله بمكة سرًّا بقصد حماية أقربائه المقربين. علمًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يدخل مكَّة على حين غفلة من أهلها حتى لا ينشب القتال وتراق الدماء. فمثل هذا الصنيع من سيدنا حاطب قد يحبط جميع الخطط، ويدفع الجيش برمَّته ومستقبل الإسلام والمسلمين إلى خطر عظيم؛ حيث إن اطلاع أهل مكة على التطورات قد يدفعهم إلى الاستعداد للقتال؛ وقد يستعينون بهوازن وثقيف، ويوقعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه في فخ خطير.
لم يكن لدى أحد خبر بهذا التطور الخطير، إلى أن نزل جبريل الأمين بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل على الفور سيدنا عليًا والزبير والمقداد ليدركوا المرأة التي تحمل الكتاب قبل أن تصل به إلى مكَّة؛ فقبضوا عليها ومعها الكتاب وأعادوها إلى المدينة المنورة1. فدعا رسول الله حاطبًا وسأله عما حمله على فعل هذا، فأخبره بالأمر وعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفض طلب البعض بإعدامه بسبب فعلته معددًا مواقف حاطب وفضائله يوم بدر 2. ولقد كان تدخل جبريل الأمين عليه السلام بنفسه في أمر هذه الرسالة يشير إلى ضرورة عدم الصمت إزاء المخاطر التي تهم الرأي العام، وأنه ليس من الصواب التغاضي عن الأمر وتجاهله، وضرورة إبلاغ وإطلاع المسؤول وصاحب القرار بالوضع على الفور.
كلمات رأس النفاق التي تبث الفرقة والنزاع
وقع نزاع بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين قد تزاحمَا على ماء بالمريسيع في غزوة بني المصطلق؛ فقال الأنصاري: “يا للأنصار”، وقال المهاجري: “يا للمهاجرين”. رأى عبد الله بن أُبيّ الذي يحاول الوقيعة بين المسلمين بكل السبل أنها فرصة سانحة للإيقاع بين المسلمين والقضاء على الأخوة التي بينهم. إذ كانت تؤرقه وحدتهم وترابطهم. فقال كلمات قاسية مهينة للمهاجرين وموبّخة للأنصار من أجل استفزازهم:
“والله ما رأيت كاليوم قطّ، والله إن كنت لكارهًا لوجهي هذا، ولكنّ قومي غلبوني، أو قد فعلوها؟ لقد نافرونا وكاثرونا في بلدنا، وأنكروا منّتنا، والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلّا كما قال القائل: “سمن كلبك يأكلك”، والله لقد ظننت أنّي سأموت قبل أن أسمع هاتفًا يهتف بما هتف به جهجاه، وأنا حاضر لا يكون لذلك منّي غير، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ. هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ أنزلتموهم بلادكم فنزلوا، وأسهمتموهم في أموالكم حتى استغنوا، أما والله لو أمسكتم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم، ثم لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضًا للمنايا، فقتلتم دونه، فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا!”.
لم تكن كلمات عبد الله بن أبيّ بالهينة التي يمكن تجاهلها. فما هي إلا مقولة قد أُعد لها مسبقًا بقصد إهانة سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلم وتأجيج نيران الفتنة بين المسلمين من خلال تخطئة وتحقير كلا الطرفين. وقد كان سيدنا زيد بن الأرقم شاهدًا على هذه الأقوال، فانطلق من فوره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر قبل أن تحدث الوقيعة بين الطرفين. فأخذ صلى الله عليه وسلم يستفسر منه عن صحة ما يقول، فقال صلى الله عليه وسلم: “يا غلام لعلك غضبت عليه!” فقال زيد: “لا والله يا رسول الله، فقد سمعته منه”، فقال صلى الله عليه وسلم: “لعله أخطأ سمعك”، قال زيد: “لا والله يا رسول الله”، قال صلى الله عليه وسلم: “فلعله شبّه عليك”، فقال زيد: “لا والله يا رسول الله”. وأخذ بعض الصحابة يطلبون منه التوبة عما نقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقادًا منهم أنه قد يكون وقع في الكذب فيما قال. فقال زيد: “اللهم، أنزل على نبيك ما يصدق حديثي”.
فلما شاع بين الجند ما قال ابن أبيّ، وليس للناس حديث إلا ما قال، أقبل عبد الله بن أبيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر مقولته، وكذَّب ما قيل في حقه. إلا أن سيدنا عمر بن الخطاب الذي سمع بمقولة ابن أبيّ، أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: “يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق ابن أبيّ، فإن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر به أنصاريًّا. مر سعد بن معاذ أو مر محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتله”. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، ولم يفعل شيئًا سوى أن أمر عمر أن يُعلم الناس بالتأهب للرحيل وكان ذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها. وبذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشغال الناس بأمر الرحيل عن الخوض في المشكلة وتفاقمها. وقضى على الفتنة قبل أن تشتعل.
لم يمر الكثير على هذه الواقعة حتى أنزل الله تعالى سورة المنافقين؛ لتؤكد صدق قول سيدنا زيد بن الأرقم رضي الله عنه، وتفضح الوجه الحقيقي للمنافقين وأفعالهم وخططهم3.
وهكذا لم يقف سيدنا زيد بن الأرقم رضي الله عنه أمام الخطر الذي شاهده، بل أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه التطورات التي تهم المجتمع الإسلامي، فأصبح وسيلة وسببًا في نزول سورة تفضح أمر المنافقين وتظهر حقيقتهم إلى يوم القيامة.
حزن شباب الأنصار
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمُس غنائم غزوة حُنين، وكانت تبلغ (4800 من الإبل، و8000 من الغنم)، فوزعها كاملة على المؤلفة قلوبهم. وكان من بين هؤلاء أصحاب الزعامة والنفوذ الذين كانوا لا يفوتون فرصة حتى الأمس للنيل من المسلمين أمثال أبي سفيان، وعيينة بن حصن، وسهيل بن عمرو. لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار من الغنائم مثل ما أعطى غيرهم، ثقة في قوة إيمانهم وسماحة نفوسهم؛ ولكن بعضهم تأثر من هذا العطاء بحكم الطبيعة البشرية، ولم يستطع أن يفهم الحكمة من هذا التصرف، فظهر بين بعض شباب الأنصار نوع من الاحتجاج على ذلك، وقالوا:
– لقد اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه وعشيرته، فما عاد له حاجة بنا.
– إنه يعطي من لم يقاتلوا، ويمنع من قاتلوا! يا له من أمر عجاب! إن الدماء لا تزال تقطر من سيوفنا، ويعطي غنائمنا في النهاية لهم.
– إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي غنائمنا أقوامًا لا تزال سيوفهم تقطر من دمائنا، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم.
– يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم! نحن أصحاب كل موطن شدة، ثم آثر قومه علينا، وقسم فيهم قسمًا لم يقسمه لنا، وما نراه فعل ذلك إلا وهو يريد الإقامة بين ظهرانيهم.
كان سعد بن عبادة سيد الخزرج وأحد سادة الأنصار من المطلعين على كل هذه الأقاويل. ولا سيما أن من تفوهوا بهذه الاتهامات والكلمات الجارحة هم أناس من قومه. فبدلًا من أن يتستر عليهم ويعتِّم على الأمر، قرر الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغه بما يُقال. فإن لم يتم التدخل فلا يُعلم ما تؤول إليه الأمور بالمسلمين. وخاصة أن هذه الانتقادات اللاذعة تنال أيضًا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: “يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم فيما كان من قسمك هذه الغنائم”.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: “اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا فِيهَا فَأَعْلِمْنِي”. إذ كان يجب في الحقيقة التدخل قبل أن تتفاقم المسألة. فلما اجتمعت الأنصار، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم بما قالوا، ووضح لهم مقصده من قسمته هذه. ثم أخذ يعدد مناقبهم وفضائلهم وجودهم وحسن إكرامهم. فلما فهموا المقصد النبوي من هذا ندموا على ما فعلوا، وبكوا حتى أخضلّت لحاهم4.
ولقد أسرع سيدنا سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الخطر القادم على الرغم من أنه صادر عن قومه، مما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة في التدخل في الوقت المناسب. فقام بحل المشكلة وحال دون الانشقاقات القوية المحتمل وقوعها بين أفراد المجتمع.
وفي اليوم نفسه أيضًا وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم تلك الغنائم جاء رجل من المنافقين يدعى معتِّب بن قشير إلى سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له: “إنها العطايا ما يراد بها وجه الله!” يقصد قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: “أما والله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت”. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمره. إذ إن مقولته هذه التي قالها دون أن يعلم الحكمة من هذه القسمة قد تكون شرارة فتنة عظيمة، وتضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف حرج مع الناس. فلما أخبره تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وقال: “يَرْحَمُ اللَّه أَخِي مُوسَى! قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ! ثم أَخبر أنَّ نبيًّا كذَّبه قومُه وشجُّوه حين جاءهم بأمرِ اللهِ فقال وهو يمسحُ الدمَ عنْ وجهِه: اللهم اغفرْ لقومي فإنهم لا يعلمون”.
سوء صنيع جُلاس بن سُويد بن الصامت
كان جلاس بن سويد أحد المنافقين الذين ظلوا سنوات طويلة يضمرون الكره والحقد الدفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره ممن تخلفوا عن غزوة تبوك. فقال: “لئن كان هذا الرجل صادقًا لنحن شر من الحمر!” كاشفًا عن عداوته التي لم يعد قادرًا على كتمانها. فقام عمير بن سعد وكان في حجر جُلاس بعد وفاة أبيه، بإخباره بأنه سيرفع مقولته الجارحة هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلًا له: “إنك لأحب الناس إلي، وأحسنهم عندي يدًا، وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقولة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولئن صمت عليها ليهلكن ديني، ولإحداهما أيسر علي من الأخرى”.
كان عمير يتيمًا، لا مال له، وكان جلاس زوجَ أمه وكافله. ولو قام عمير بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقولة عمير لبقي جائًعا محرومًا. ولكنه من جانب آخر ثمة اعتداء لفظي على شخص النبي صلى الله عليه وسلم المرشد والقائد لجميع المسلمين، والممثل لدعوة الله تعالى، فالصمت أمام مثل هذه المواقف هو خيانة للدعوة، وغدر وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مشى عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع في صبر وهدوء. فلم يكن يتعجل في اتخاذ القرار في مثل هذه المواقف، بل يدقق ويحقق في الواقعة من كل جوانبها، ويتحرك بناءً على ذلك؛ لذا دعا جلاسًا وأخبره بما قال عمير. فحلف جلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: “لقد كذب عليّ عمير، وما قلت ما قال عمير بن سعد”.
لقد كان عمير في نفس المجلس، وجلاس يوجه إليه تهمة الكذب التي هي من أمارات النفاق. فدعا عمير ربّه أن ينزِل قرآنًا يثبت صدق قوله، ويبرئه من هذه التهمة الكاذبة. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (سورة التَّوْبَةِ: 9/74).
لقد ظهر الأمر للعيان، فقد أقحم جلاس نفسه في مأزق كبير، فجلس مطأطِئًا رأسه ينتظر ردة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجرم العظيم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وعفا عنه. وقد كان هذا العفو سببًا في ذوبان النفاق من قلبه، وإدراكه حقيقة الإيمان، والندم على ما صنع. ثم توجه بعدها بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى، فحسنت توبته، حتى عُرف منه الخير والإسلام5.
خلاصة القول
كان المجتمع العربي حتى مقدم الإسلام عبارة عن قبائل متفرقة تعيش في قتال دائم مع بعضها البعض، حتى إن فروع القبيلة الواحدة كانوا في صراع مستمر. فلم يكن هناك أمان، لا في الشوارع ولا في الطرقات. فأصبح الصحابة الذين كانوا حتى الأمس يعيشون في هذه البيئة القاسية يشعرون حقيقة بهذا المناخ الآمن الذين حازوا عليه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلام الداخلي والاستقرار والتكافل والتضامن؛ لذلك كانوا يعيشون دائمًا في يقظة، ولا يدعون أي مجال لأي قول أو فعل يثير الفتن التي تهدد جو الأخوّة؛ فكانوا يخبرون على الفور رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقع من مشكلات. فلم تكن تخامرهم فكرة: “ليس هذا من شأني! لا داعي إلى ذلك! لو تطلب الأمر لنزل جبريل!”… لقد كانوا يرون أي شيء يتسبب في إثارة الفتنة بين المسلمين أمرًا مهمًّا لا يمكن السكوت عليه. وكما رأينا في الأمثلة السابقة كانوا لا يخشون مكانة من أراد إثارة الفتنة، ولا مدى قرابته أو بعده منهم. فلا يتوانون حتى عن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي قول يستهدف شخصه الكريم مهما كان ثقل هذا القول، فلا يفكرون من قبيل: “لو أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلربما حزن، أو غضب”؛ لأنهم يعلمون أن ما قد يلحق المسلمين من فتن وهرج ومرج بسبب هذه الأقاويل هو أكثر وقعًا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإساءات التي تستهدف شخصه الكريم. ولقد كانوا يفعلون ذلك رغم خطر مواجهة الاتهام بالكذب والافتراء والإنكار من مخاطبه، وذلك لأن سلامة الدعوة والمجتمع كانت تغلب بكثيرٍ راحتَهم الشخصية واعتبارهم.
لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوم أو زجر من يأتي إليه بالخبر لمواجهة هذه الفتن التي تهدد وحدة واتحاد المسلمين، وذلك من أجل تنشئة الصحابة وإنشاء المجتمع المسلم. بل كان يتخذ موقفًا ممن يحملون خبرًا عن شخصه، فيقول: “لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شَيْئًا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ”6. وكان لا يحقر ولا يقلل من شأن أي خبر يهم أمن وسلامة المجتمع والرأي العام، فلا يقول: “أيحدث شيء كهذا!”، فيأخذه على الفور على محمل الجد، ويتحرى صحته، فإذا ما تأكد منه يتدخل في الوقت المناسب. فيتحدث ويتحرك في سبيل إخماد الفتنة قبل اشتعالها. ثم لا يقترب أساسًا من فكرة معاقبة أصحاب المشكلة، بل يخطو خطوات من شأنها استعادتهم إلى المجتمع مجددًا. فيحل المشكلة دائمًا بالحلم والرفق والعفو والشفقة والرحمة، ولا يسمح بخرق سفينة المجتمع.
Footnotes
- صحيح البخاري، المغازي، 46
- صحيح البخاري، الجهاد، 141
- ابن هشام، السيرة النبوية، 2/180-182.
- صحيح البخاري، المغازي؛ صحيح مسلم، الزكاة؛ أحمد بن حنبل، المسند، 3/89؛ ابن هشام، السيرة النبوية، 591، 592؛ البيهقي، دلائل النبوة، 5/180
- ابن هشام، السيرة النبوية، 2/345؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 1/276؛ ابن الأثير، أسد الغابة، 1/549.
- سنن الترمذي، المناقب، 33؛ سنن أبي داود، الأدب، 28؛ أحمد بن حنبل، المسند، 1/395.
